ثلاث سياسات في ثلاثة سيناريوهات.. طريق الشيوعية نحو الاقتدار السياسي
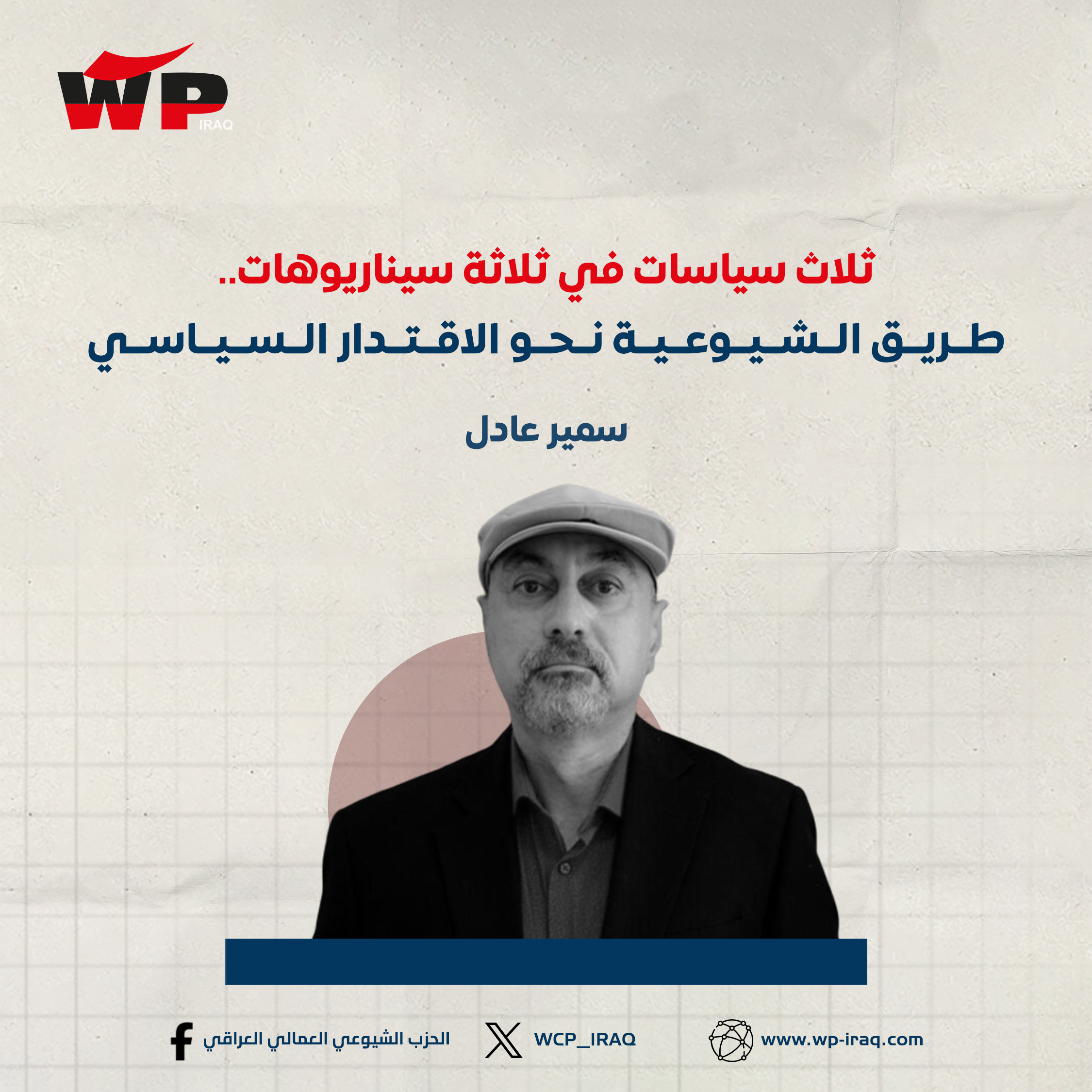
سمير عادل
شيوعية ماركس، كما هي شيوعية لينين، والتي عبّر عنها بجلاء ووضوح منصور حكمت، هي التغيير في حياة البشر نحو عالم أفضل. وأيّ نوع من “الشيوعيات” لا يسعى إلى هذا التغيير، فهو شيوعية كلّ شيء، إلا شيوعية ماركس.
إن الأيديولوجية الماركسية هي الراية النظرية للشيوعية، وهي المنهج الذي يُسلّط الضوء على الطريق نحو السلطة السياسية. والماركسية، كما تحدثنا عنها سابقًا في (الماركسية والترف الفكري)، ليست قلادة نعلّقها على رقابنا ونتباهى بها في منتديات المثقفين وجلساتهم العقيمة، تلك التي لا تُغني الطبقة العاملة، ولا النساء، ولا الشباب التوّاقين للحرية والمساواة.
وعليه، فعلى الشيوعية أن تفكر بعمق: ما هي مفاتيح السلطة؟ وقبل ذلك، كما علّمنا منصور حكمت، ما هي مفاتيح الاقتدار السياسي؟ كيف يمكن أن تكون الشيوعية طرفًا في المعادلة السياسية، وكيف تُغيّر موازين القوى لصالح العمال وجميع محرومي المجتمع؟ وفي المنعطفات السياسية والتاريخية التي يمر بها المجتمع، على الشيوعية أن تبتكر الطرق والآليات وتخلق الرافعات السياسية نحو الاقتدار السياسي.
فالشيوعية التي لا تخلق الفرص، اولا تغتنمها، ستجد نفسها في ذيل الحركات السياسية، منعزلة عن المجتمع، وأقصى ما تناله هو احترام “المحاربين القدماء” الذين يمنحونها أوسمة النُبل الأخلاقي، وهي في الحقيقة أفضل وسيلة لتعظيم الذات في المخيلة الوهمية، وفي الوقت نفسه تُقدّم لنفسها العزاء لتخفيف ألم انعزالها عن المجتمع. وإن من الخطأ أن تُلقي الشيوعية باللائمة على المجتمع، متهمةً إياه بالتخلّف والرجعية وعدم أهليته للتغيير، بدل أن تضعه أمام خيارها هي — خيار الشيوعية.
الانتفاضة والثورة:
وكما تُعلّمنا كل التجارب التاريخية، فإن للانتفاضات والثورات قوانينها الموضوعية، وإن اندلاعها يحدث خارج إرادة الأحزاب السياسية، مهما كانت قوتها أو تنظيمها.
وقد شرح فلاديمير لينين هذه المسألة تفصيلًا في كراسه المعروف «إفلاس الأممية الثانية»، حين تحدث على ان الثورة لا تحدث دون وضع ثوري، وليس كل وضع ثوري يؤدي الى ثورة، مبيّنًا أن شروط هذا الوضع تتمثّل في: عجز الطبقات السائدة عن الاحتفاظ بسيادتها دون أي تغيير، ودون أن تنشب في صفوفها أزمة في سياستها، وعدم قدرتها على الاستمرار في الحكم بالطريقة القديمة. وفي الوقت نفسه، ترفض الجماهير مواصلة العيش تحت حكم هذه الطبقات، حيث يصل فقرها وشقاؤها إلى درجة لا تُحتمل. وفي اللحظة ذاتها، يتفاقم وضعها إلى حد يجعلها لا تقبل بالأزمة التي تعصف بـ«القمة»، ولا بأوضاعها القائمة، فتندفع للمشاركة في العاصفة الثورية.
وحين تندلع الثورات، تتدخل الأحزاب السياسية، كلٌّ بحسب أفقه الاجتماعي والسياسي، في محاولة لتوجيه مسار الثورة والسيطرة على مجراها من أجل أن تكون طرفًا في المعادلة السياسية، أو الوصول إلى السلطة السياسية ذاتها — كما حدث في تجربة ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917.
وفي ذلك المنعطف التاريخي، طرح لينين ثلاث تكتيكات سياسية بين شهر شباط وشهر أكتوبر أي خلال اقل من ثمانية اشهر، فعند اندلاع ثورة شباط وجه بعدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة، وبعد ذلك مثلما جاء في كراسه الشهير «موضوعات نيسان» (أطروحات أبريل)، حيث حدد بجلاء الموقف العملي للبلاشفة من الثورة والدولة والسلطة، ورفع شعار كل السلطة للمجالس. وأخيرا عندما ذهب الى ثورة أكتوبر للإطاحة بالسلطة البرجوازية.
إن الثورات لا تحدث كل يوم، ولا تتوفر دائمًا الظروف الموضوعية التي تهيّئ الوضع الثوري. فهي، كما وصفها المفكرون الماركسيون، انها قُاطرات التاريخ. وخلال القرن الماضي، لم تندلع سوى أربع ثورات كبرى اثرت على مجرى تاريخ البشرية في القرن العشرين، ويمكن اعتبارها وفق المعايير الماركسية ثورات اجتماعية حقيقية: ثورة أكتوبر في روسيا عام 1917، الثورة الإيرانية عام 1979، وثورتا مصر وتونس عام 2011 وبغض النظر ما الت اليها نتائجها.
من هنا، لا ينتظر الشيوعيون الثورة كي يتحركوا ويتحدثوا عن التغيير، وألا يُرجئوا الفعل السياسي إلى أجلٍ غير معلوم، بانتظار ما يُسمّى “اليوم الموعود”، أي يوم الثورة، او كما جاءت في الادبيات الدينية انتظار ظهور المسيح او المهدي المنتظر.
سيناريو مظلم.. تدمير اركان المجتمع:
أما السيناريو الثاني، وهو منعطف جديد على التجربة الشيوعية، فقد عايشنا فصوله في العراق، حين دخل المجتمع في سيناريو قاتم ومظلم. وذلك عندما تهدم كل أركان المدنية في المجتمع على أثر الغزو واحتلال العراق عام ٢٠٠٣، ولم تبقَ أية أسس للدولة بالمعنى القانوني والسياسي لحماية المواطنين، وحين انعدم الأمن والأمان وتحكمت الميليشيات في مقدرات المجتمع وحياة الجماهير. وكان اندلاع الحرب الأهلية الطائفية في شباط ٢٠٠٦ مرحلةً تاريخيةً فارقة فرضت على الشيوعية أن تفكر بدور جديد، بوصفها صاحبة المجتمع لا مجرد معارضة سياسية.
وفي مثل هذه الظروف، يتعيّن على الشيوعية أن تعيد تنظيم نفسها وفق الآليات التي يفرضها واقع ما بعد الغزو والاحتلال؛ أي من خلال تأمين مناطق يسود فيها الأمن والأمان كعنصرين أساسيين وجوهريين، وأن تُقام فيها علاقات مساواة بين ساكنيها، مع منع أي نزعات قومية أو دينية أو طائفية يمكن أن تهدد استقرارها، مع أخذ ذلك بنظر الاعتبار وإيجاد السبل والطرق المناسبة والممكنة لمقاومة الاحتلال الذي تسبب بكل هذه المأساة. ولا يتحقق ذلك إلا عبر تنظيم الأهالي في تلك المناطق، وتشكيل قوى أمنية محلية تقودها الشيوعية بأشكال مختلفة بهدف حماية الجماهير وضمان أمنها الذاتي.
ويمكن رؤية نموذج آخر لهذا السيناريو بعد سقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش، حيث كان لزامًا على الشيوعية في تلك المرحلة أن تشكّل قواها وتنظّم الجماهير لمواجهة الهمجية والوحشية التي مثّلها داعش. بيد بالرغم من محاولات، وخاصة في مدينة السليمانية، وإرسال قوة للانضمام إلى مقاومة داعش في مدينة خانقين والمناطق التابعة لمحافظة ديالى الا انها لم ترتقِ إلى مستوى المطلوب وتظهر الشيوعية كقوة منظمة للجماهير بالتصدي لعصابات داعش، وبغض النظر عن الأسباب التي حالت دون ذلك.
لقد قدّمت تجربة كوباني السورية مثالًا حيًّا على ذلك، إذ استطاعت الجماهير هناك، أن تتصدّى لداعش وتلحق به هزائم ساحقة، وتحولت كوباني إلى رمزٍ للمقاومة، وإلى الصخرة التي تحطّمت عليها آلة داعش الوحشية، المدعومة من عدد من الدول الإقليمية، وتلا سقوطها انهيار معاقل التنظيم واحدة تلو الأخرى. لم تكن لتلك الجماهير ان تنظم نفسها وتتصدى لداعش لو لا وجود قوة منظمة ورائها التي نتجت عنها قوات سورية الديمقراطية المعروفة بقسد وقوات حماية النساء وبغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا معها.
في مثل هذه الأوضاع، ومع تراجع المجتمع إثر السيناريو المظلم، تتراجع كذلك إرادة الجماهير، وعلى الشيوعية أن تلعب دورها في إعادة النهوض بهذه الإرادة وتقويتها عبر المبادرة بالدفاع عنها وتنظيمها.
وفي كلا المنعطفين — سواء في حالة الوضع الثوري، أو في حالة السيناريو المظلم كما في العراق — إذا استطاعت الشيوعية أن تلعب دورها وتبتكر آليات التدخل المناسبة، فإنها تتحول إلى قوة اقتدار سياسي حقيقية، تصبح لاعبًا رئيسيًا في المعادلة السياسية، وتفتح الطريق نحو السلطة السياسية، أو على الأقل تؤثر في القرارات والقوانين التي تُسنّ لصالح الطبقة العاملة والجماهير المحرومة.
ظروف مجتمع طبيعي:
اما السيناريو الاخر، هو وجود مجتمع طبيعي — أي مجتمع يسوده قدر من الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتتوفر فيه مؤسسات الدولة، وتُمارس فيه الحياة المدنية بمعناها العام.
في مثل هذا الوضع، على الشيوعية أن تفكر بكيفية تغيير واقع الناس وحياتهم اليومية. وتغيير أوضاع الجماهير لا يتحقق إلا عبر خوض صراع سياسي شامل على جميع الجبهات مع الطبقة البرجوازية، ومن بين هذه الجبهات الأساسية: تحويل الشيوعية إلى قوة اقتدار سياسي تكون جزءًا مؤثرًا في المعادلة السياسية لصالح الجماهير. وتُعدّ الانتخابات — سواء على المستوى المحلي كالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، أو على المستوى البرلماني العام — واحدة من التكتيكات السياسية المهمة التي يجب على الشيوعية خوضها بوعي وثبات.
فبالنسبة إلى شيوعية ماركس، لا وجود لأي توهّم بالانتخابات البرلمانية، إذ ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة مؤقتة للتعبير عن الصراع الطبقي في ميدان سياسي مفتوح. وكما يقول منصور حكمت، فإن الطبقة العاملة وعموم المجتمع حينما يختارون الأحزاب البرجوازية في الانتخابات، فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون تغيير أوضاعهم المعيشية، ولكنهم لا يجدون بديلًا سياسيًا ملموسًا يمثل مصالحهم الطبقية.
من هنا يُطرح السؤال الجوهري أمام الشيوعية: هل بوسعها أن تكون البديل الحقيقي لتغيير حياة العمال؟ إن البرلمان هو ظاهرة فرضتها البرجوازية على المجتمع، وعلى الشيوعية أن تتعامل معها بذكاء سياسي، وتستفيد منها كمنبرٍ للنضال الطبقي. فوجود ممثلي الشيوعية في البرلمان يدفعها خطوات إلى الأمام على الصعيد الاجتماعي والسياسي والتنظيمي في آنٍ واحد. ويتحول البرلمان، عندئذ، إلى ساحة صراعٍ سياسي مكشوفة يخوضها ممثلو الشيوعيين والطبقة العاملة.
إنّ الإصلاحات التي تعمل من أجلها الشيوعية، والتي جاءت في القسم الأول من برنامج الشيوعية العمالية (عالم أفضل)، هي ذاتها البرنامج الانتخابي الذي جاء في بيان الحزبين الشيوعي العمالي العراقي والكردستاني؛
- سنّ قانون عمل إنساني وتقدمي،
- تشريع قانون المساواة الكاملة بين المرأة والرجل،
- ضمان اجتماعي شامل للعاطلين عن العمل،
- كفالة حرية التنظيم النقابي، والإضراب، والتظاهر،
- مجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية بما فيها الجامعات الاهلية.
- وترسيخ الحريات السياسية والفكرية.
إنّ هذه الإصلاحات لا يمكن فرضها على البرجوازية دون نضال واعتماد تكتيكات سياسية، ومن بين هذه التكتيكات الظروف التي تتيحها لنا الانتخابات. إذن، فالانتخابات هي وسيلة وتكتيك سياسي للتعريف ببرنامجنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي أمام الطبقة العاملة وعموم المجتمع، وهي فرصة للشيوعية لكي تعرض نفسها بوصفها خيارًا بديلاً في مواجهة الخيارات البرجوازية الأخرى في المجتمع. وعبر هذا الصراع، تُبيّن الشيوعية للطبقة العاملة حقيقة البرلمان البرجوازي، ومن يمثله، وما هي مصالحه الطبقية الحقيقية.
وعندها – وفقط عندها – لا يمكن حذف الشيوعية من المشهد السياسي، لأن حذفها يعني بالضرورة حذف حقوق العمال والنساء والشباب، التي تصبح متجذرة في المجتمع. وعندها فقط تقترن الشيوعية بالجماهير العمالية والتواقة للحرية والمساواة.
المقاطعة والمشاركة، تكتيكان سياسيان:
وكما عبّرنا عنها سابقًا في مقابلة مفصلة مع صحيفة (الى الامام) حول الانتخابات، فإن المقاطعة بالنسبة إلى الشيوعية هي تكتيك سياسي بنفس أهمية المشاركة، وكلاهما وسيلة تُحدَّد وفق الظروف السياسية والاجتماعية القائمة.
فإذا كانت المقاطعة قادرة على دفع الشيوعية والجماهير نحو تعميق الأزمة الثورية، أو فرض التراجع وانتزاع التنازلات من البرجوازية، فعلى الشيوعية أن تختار هذا التكتيك بوعيٍ وثبات.
لكن في وضعنا الراهن، لا توجد ظروف ثورية يمكن من خلالها قلب الأوضاع إلى ثورةٍ تكتسح السلطة السياسية القائمة.
الظرف السياسي.. تغيّر أم لم يتغيّر؟
يستند الرأي القائل بعدم جدوى المشاركة في الانتخابات إلى فكرة مفادها: ما الذي تغيّر؟ فالميليشيات باتت أقوى، والهجمة على الحريات أشرس، وتمّ سنّ قوانين معادية للمرأة وحرية التعبير، واتسعت هيمنة الميليشيات وتطاولها على المجتمع، وبالتالي فإن المشاركة في الانتخابات تعني الاعتراف بالعملية السياسية، وعلى هذا الأساس يجب الاستمرار بالمقاطعة.
في الحقيقة، إن العملية السياسية قائمة أصلًا، ومستقلة عن إرادة المجتمع، رغم كونها مبنية على نظام المحاصصة الطائفية والقومية، وينخرها الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها، وبعيدة كل البعد عن مصالح الجماهير. والاعتراف من عدم الاعتراف بالعملية السياسية لا يغير شيئا لصالح الجماهير التواقة للحرية والمساواة.
نعم، لم يتغيّر شيء، ونتفق بأن الأوضاع أصبحت أكثر قتامة، لكن الغريب في هذه المقاربة أن أصحاب هذا الرأي يضعون المجتمع في حالة انتظار سلبي، وكأنهم ينتظرون ولادة ظروف ديمقراطية خالصة لانتخاب برلمان برجوازي ديمقراطي “جاهز” كي يشاركوا فيه لاحقًا!
ما تغفله هذه المقاربة أن الطبقة البرجوازية الحاكمة في العراق، التي يهيمن عليها الإسلام السياسي الشيعي، ماضية في مشروع بناء دولة استبدادية بهوية طائفية. وهذه الطبقة لا تتحرك بمعزل عن النظام الرأسمالي العالمي، الذي لا مشكلة لديه مع القوانين القمعية المذكورة.
لقد أشرنا سابقًا مرارًا إلى أن العراق يحتل موقعًا محددًا في تقسيم العمل الرأسمالي العالمي: صناعة النفط، وتوفير العمالة الرخيصة لضمان تراكم رأس المال الإمبريالي داخل السوق العراقية. وهذا ما تسعى إليه الطبقة الحاكمة، وتعمل على تثبيته من خلال: قمع الاحتجاجات العمالية والجماهيرية، سن قوانين معادية للعمال والنساء، فرض هوية طائفية للدولة، تقييد الحريات..الخ.
أما انتظار حلّ الميليشيات وتوفير بيئة مثالية لسيادة أجواء الحرية والديمقراطية من قبل الطبقة البرجوازية الحاكمة في العراق، فهو ضربٌ من الأوهام أكثر مما هو ضربٌ من الخيال.
إن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة أو إنهاء السلاح المنفلت — وهي الجملة الخجولة أو “العنوان-الاسم الحركي” لاحتواء الميليشيات — يعني عمليًا احتكار العنف من قبل الدولة التي يُراد بناؤها بهوية طائفية، لتكون أداةً لتصفية المعارضين، ومسعى لخلق انسجام سياسي داخل الطبقة البرجوازية الحاكمة بما يتلاءم مع متطلبات رأس المال العالمي الذي أشرنا إليه.
وفي الوقت ذاته، لا ترى الرأسمالية العالمية أي مشكلة في إطلاق يد الميليشيات لممارسة العنف كلما اقتضت الحاجة لحماية رأس المال، مع بقاء هذه الميليشيات على حالها، شرط تقنينها ضمن مؤسسة ما، سواء في “الحشد الشعبي” أو في الجيش والشرطة — شرط ألّا تُعكّر مزاج المصالح الإمبريالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
إن الطبقة الحاكمة لن تتراجع طوعًا عن مشروعها، بل على العكس، تمضي فيه بثبات. والتراجع الوحيد الممكن لا يحدث إلا حين تتغيّر موازين القوى لصالح الجماهير. وتغيير هذه الموازين لا يتم عبر الانتظار أو الانعزال، بل من خلال: تقوية الحركات الاحتجاجية من اجل توفير فرص العمل وتقليل ساعات العمل وزيادة الأجور والضمان الاجتماعي، تشديد النضال ضد القوانين المعادية للمرأة، مواجهة مشاريع خصخصة التعليم، تنظيم الجماهير في النقابات المهنية والعمالية والطلابية، بناء شبكات قوة في الأحياء والمناطق حول مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية واضحة. عبر هذه الأساليب النضالية، يمكن تغيير موازين القوى، وفرض قوانين لصالح الطبقة العاملة والجماهير المحرومة. وعلى الشيوعية إيجاد القنوات وخلق الفرص المختلفة لاقتدار الصف المستقل للجماهير.
وفي هذا الإطار، المشاركة الواعية في الانتخابات يمكن أن تكون قناة سياسية من بين القنوات الممكنة، تُستخدم لتقوية صوت الجماهير وتنظيمها، وتحويل الصراع من هامش العملية السياسية إلى مركزها، بدل البقاء خارج مسرح الصراع حيث تقرر الطبقة الحاكمة كل شيء.
وأخيرًا، حين ترى الطبقة العاملة والنساء والشباب والمثقفون التقدميون ممثليهم في البرلمان يتصارعون على سنّ القوانين التي ذُكرت آنفًا لصالحهم، تزداد ثقتهم وشعبيتهم بالشيوعية، ويدركون بشكلٍ أعمق عدالة قضيتهم وحقانيتها.
وعندئذٍ، تتجسد الشيوعية في المجتمع بكل ميادينه — في البرلمان والشارع، والمحلات، والمصانع، والدوائر، والتجمعات — وتتحول إلى قوة فاعلة في حقل السياسة لا يمكن تجاهلها.
وهناك، في خضمّ هذا التفاعل الاجتماعي والسياسي، تستطيع الشيوعية أن تقول كلمتها الفصل لصالح الجماهير، وأن تهيئ نفسها لأي تحولات سياسية أو تاريخية مقبلة، من انتفاضاتٍ وثوراتٍ، تسعى من خلالها إلى انتزاع السلطة السياسية من البرجوازية وإقامة سلطة الطبقة العاملة والجماهير المحرومة.


